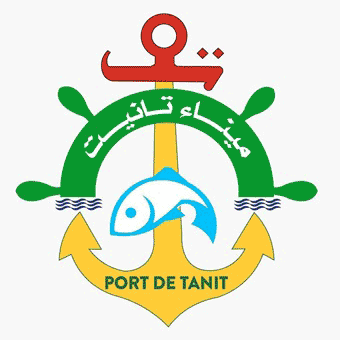يتزايد مؤشر الاهتمام بالسياسة مع اقتراب موعد الانتخابات الرئاسية القادمة في موريتانيا. وكان ذلك الحدث سيكون عاديا لولا حدوث بعض التغيرات المهمة في البلد تجعلنا ربما أمام أهم حدث سياسي يعرفه البلد منذ الاستقلال: خريطة سياسية معقدة ومعطيات اقتصادية متضاربة وأوضاع اجتماعية في غاية التأزم ومستقبل بقدر ما يبشر بآفاق اقتصادية واعدة ينذر بحدوث أوضاع سياسية أو اجتماعية استثنائية قد تحدث في أية لحظة.
من الناحية السياسية هناك الرئيس المنتهية ولايته والذي أعلن في خطوة جريئة نيته عدم الترشح لمأمورية ثالثة، وأغلبية رئاسية منقسمة على نفسها ولم تدخل نفسيا بعد في مرحلة التحضير للسباق الرئاسي لأسباب تكتيكية قد لا تكون صحيحة بالضرورة، ومعارضة قد تقودها تكتيكاتها المضادة وحساباتها الخاطئة وغياب الرؤية الاستشرافية للمستقبل إلى تضييع الفرصة كعادتها.
ومن الناحية الاقتصادية وبغض النظر عن المؤشرات الاقتصادية السلبية و"الحمى" التي يعرفها "عملاق" الشمال الذي مثل على مدى عقود من الزمن شريان الحياة للاقتصاد الوطني، هناك في المقابل طفرة منتظرة في مصادر الطاقة لم يتم حتى الآن التحضير لكيفية استغلالها استغلالا أمثل لا من ناحية التخطيط الاقتصادي الصحيح الذي يجعلنا نستفيد منها استفادة قصوى أو السبل الكفيلة بتوزيعها توزيعا عادلا وهو ما يطرح بالفعل أسئلة عديدة تتعلق بجودة الحكامة.
ومن الناحية الاجتماعية وضع اجتماعي خطير مشحون بالتوترات يتزايد فيه الغبن وسوء توزيع الثروة والمعرفة والسلطة.
في هذه الظروف ترتكب الأغلبية خطأ فادحا إذا ظنت أن الأمور يمكن أن تستمر على ما هي عليه أو أن الحلول التي اعتمدت في الانتخابات الماضية ممكنة في الانتخابات الرئاسية المقبلة.
وترتكب المعارضة خطأ أكثر فداحة إن هي اعتقدت في إمكانية حدوث تغيير كلي وانقلاب للأوضاع بزاوية 180 درجة؛ أو إن هي اعتقدت أنها قادرة على دحر النظام عن طريق صناديق الاقتراع في ظل الاختلال المستمر في ميزان القوى والخلل الواضح في قواعد اللعب النظيف ذلك أن نظامنا السياسي بحسب الدلالة الشاملة لهذه العبارة هو مثل كرة الوجود عند ابن عربي ذات وجهين: إذا نظرت فيها إلى الذات الأحدية قلت "حق"، وإذا نظرت فيها إلى الكثرة الأسمائية قلت "خلق" لكنهما في نهاية الأمر وجهان لعملة واحدة فكذلك هو الحال في نظامنا السياسي إذا نظرت إلى واجهته السياسية التي تمثلها الدولة المدنية - والتي هي للأسف واجهة مموهة وغير حقيقية - وجدت نظاما سياسيا مدنيا متكاملا من حيث الشكل بسلطاته الثلاث التنفيذية والتشريعية والقضائية مدعومة بمنظومة حقوق مكتسبة في الظاهر، وإذا نظرت إلى الواجهة الأخرى أي الواجهة الحقيقية أو الدولة العميقة وجدته نظاما قبليا تقليديا بزعاماته التقليدية المتنفذة وتراتبيته الاجتماعية المقدسة نظام جامد un système figé يُحتفظ فيه لكل فرد بمكانته الأصلية وتسوده إلى حد كبير منظومة حقوق متوارثة على أساس علاقات الولاء والتبعية الموروثة والتقسيم الطبقي . وقد يتطور ذلك النظام قليلا كما حدث في الوقت الحالي فتأخذ العلاقات القائمة على القوة وخصوصا القوة العسكرية مكانها ضمن شبكة العلاقات الاجتماعية دون أن تغير شيئا في طبيعة النظام وفي طريقة اشتغاله.
وهذا هو ما أسميناه بغياب قواعد اللعب النظيف الذي ظل يمنع المعارضة وسيمنعها ما دام ذلك النظام قائما من تحقيق أهدافها والوصول إلى السلطة بطرق ديمقراطية، وهو ذاته النظام الذي يولد الغبن والتفاوت ويخلق الحساسية بين الأوساط الاجتماعية المختلفة. هذه للأسف هي حقيقتنا التي لن يغير استنبات الديمقراطية فيها شيئا كبيرا ولن تكون قادرة في ظلها على الإثمار حتى وإن أورقت وأزهرت.
لذلك فإن تفكيك ذلك النظام والقضاء عليه هو شرط أساسي لا بد منه لنضج تجربتنا الديمقراطية وهو أمر لا يمكن أن يحدث إلا بواسطة التربية وإصلاح المدرسة التي تعمل على ترسيخ قيم المواطنة وثقافة المساواة وزرعها في أذهان مواطني المستقبل وستنال الأجيال الحالية نصيبها من ذلك أيضا وإن بدرجة أقل.
هذا الأمر يحتم علينا جميعا استثمار الفرصة والاستعداد الجيد للدخول في هذه المرحلة الحاسمة من تاريخنا بفكر استراتيجي يتطلع إلى المستقبل بإيجابية وليس بنظرة تكرس الواقع المريض أو الحاضر المؤلم أو تلتفت إلى ماض لن ينفعنا في أحسن الأحوال.
بناء على ذلك ومن خلال قراءتنا للوضع واستشرافنا للمستقبل تبين لنا أن هناك خيارات ثلاثة متاحة يتعين العمل على ترجيح كفة الأفضل من بينها جميعا بناء على ثلاثة مبادئ أساسية وحيوية بالنظر إلى الوضع الذي أشرنا إليه آنفا وهذه المبادئ هي:
مبدأ الأمن والاستقرار
مبدأ تطوير الديمقراطية والحكم الرشيد
مبدأ التوزيع العادل للثروة
فلا معنى للاستقرار والأمن إذا لم يكن هناك توزيع عادل للثروة بين مواطنين أحرار ومتساوين؛ ولا معنى للتراكم في التجربة الديمقراطية والحكم الرشيد في ظل واقع يطبعه الاضطراب وانعدام الأمن؛ ولا معنى للحكم الرشيد والتوزيع العادل للثروة إذا لم تكن هناك ديمقراطية تنمو وتتطور بشكل مطرد.
بناء على تلك المبادئ الحيوية وباستقراء الأوضاع الحالية تكون لدينا ثلاث خيارات ما دام الأمر يتعلق بإرادتنا وقدرتنا على التخطيط للمستقبل:
□ خيار لا يمكن أن أسميه بالسيء ما دام في ذاته خيارا ديمقراطيا ولكنه سيء بالمقارنة مع الخيارين الآخرين وهو أن يحدث انتقال للسلطة في هذه الظروف إلى المعارضة الأمر الذي لا يجوز استبعاده لأسباب عديدة سنأتي على ذكرها فيما بعد فالمعارضة مع ضعف خبرتها بملفات حساسة تتعلق بالأمن القومي وجهلها لقيمة المتغيرات في معادلة الأمن الخارجي في محيط إقليمي مضطرب وبالتوازنات الداخلية الهشة، وحساسيتها المفرطة تجاه الوضع الداخلي وخصوصا تجاه المؤسسة العسكرية وهي ركن ركين من أركان النظام الذي ظل يحكم البلد على مدى خمسة عقود من الزمن، واستعدادها التلقائي لفتح الملفات المتعلقة بأخطاء الحكامة السياسية والاقتصادية لنظام الرئيس المنهية ولايته... كل هذه الأمور ستؤدي بالضرورة إلى ردود فعل أشبه ما تكون بردود الفعل التي حدثت في بلدان ما سمى بالربيع العربي وخلق جو جديد من الاضطراب والفوضى قد تستغله أطراف معينة خصوصا في المؤسسة العسكرية لإعادة الأمور إلى "نصابها" والعودة بنا إلى المربع الأول وبالتالي انهيار ما كان يصلح لأن يكون لبنة أولى في البناء الديمقراطي الذي أنجزناه معا بجهد جهيد.
وهنا يمكننا الحديث عن متلازمتين في كل منها طرف سلبي وهما:
•التغاضي عن أخطاء الحكامة في مقابل التراكم المطلوب في التجربة الديمقراطية
•الاجتثاث والمحاسبة في مقابل خطر الفوضى والعودة إلى المربع الأول.
السؤال هو :هل ما يجنيه البلد من الاجتثاث والمحاسبة التي قد تؤدي إلى تقويض النظام الديمقراطي كما في كل مرة أفضل أم حصول التراكم الضروري والتقدم المطرد لنظامنا الديمقراطي الهش لأسباب عديدة ؟! ألا تقتضي المصلحة العليا غلق تلك الملفات صونا لتجربتنا الديمقراطية من الانهيار مرة أخرى في مقابل اتخاذ الإجراءات الضرورية لتحصين نظامنا السياسي ضد حدوثها في المستقبل وقد عرفنا المآسي التي جرتها سياسة الاجتثاث في دول عربية شقيقة دفعت المسؤولين فيها إلى التراجع عنها لعواقبها الوخيمة.
وفي الحقيقة فإن هناك عوامل عديدة ترجح كفة الخيار الأول وهو خيار وصول المعارضة إلى السلطة نذكر منها على سبيل المثال:
الأزمة الاجتماعية الخانقة وشعور بعض المكونات الاجتماعية بالغضب من سياسيات الإقصاء والتهميش التي تعرضت لها وبشكل أخص خلال المأمورية الثانية للرئيس محمد ولد عبد العزيز
تآكل الغطاء الأيديولوجي للنظام والفتور الملحوظ في دعم النخبة الفكرية والانقسام غير المسبوق لأغلبيته الحاكمة في مقابل قوة التصميم لدى المعارضة التي قد ترتكب بدرها خطأ تكتيكيا واستراتيجيا كبيرا عندما تعتقد أنها قادرة على دحره في ظل قواعد اللعبة المتبعة حاليا: قد تستطيع دحره على مستوى النظام السياسي المدني الظاهري لكنها لا تزال بعيدة عن ذلك بمعايير النظام الحقيقي المتحكم في مقاليد الأمور. والأسوأ من ذلك كله أن تنجر إلى منافسة السلطة في كسب وده كما أصبحنا نرى للأسف في بعض الأحيان لأن الخاسر حينئذ هو التجربة الديمقراطية نفسها وبالتالي انعدام البدائل الديمقراطية الحقيقية للاختيار الحر.
دور الرئيس المنتهية ولايته الذي أصبح من المستحيل الآن أن يلعب دورا مماثلا للدور الذي قام به في الانتخابات التشريعية والجهوية والبلدية الماضية حينما أنقذ أغلبيته من هزيمة محققة فقد اختلفت الأمور الآن ولم يعد بمقدوره أن يلعب دور المخلص لأنه سيتحول في أحسن الأحوال للدعاية لشخص آخر الأمر الذي لا يدركه المواطن العادي في الدولة العميقة والذي لا ينظر سوى إلى المظاهر.
دور بعض الشركاء الدوليين المهمين وبعض الأطراف الإقليمية التي باتت تنتظر حدوث التغيير بفارغ الصبر.
□ الخيار الأسوأ وهو التغيير العنيف أو التغيير اللادستوري مهما كانت طبيعته. ولهذا الخيار أيضا عوامل تؤدي إلى حدوثه منها:
عمل السلب (le travail du négatif) وهو القناعة الراسخة لدى بعض الأطراف في النظام الحاكم - سواء أصابوا في ذلك أو أخطأوا- بأن أي تحول للسلطة سيكون على حساب مصالحهم وبالتالي يبذلون ما في وسعهم لإقناع الرئيس بالعدول عن قراره الوطني الشجاع في التخلي عن السلطة والتخطيط لمأمورية ثالثة بطرق ملتوية الأمر الذي قد يؤدي في حال حدوثه إلى تسريع وتيرة الخيار الأسوأ.
مؤسسة عسكرية مدمنة على السلطة وأصبحت هي "الجوكر" الذي يعول عليه لا في الاستقرار والأمن فحسب بل وفي قلب الأوضاع أيضا بطريقة غير ديمقراطية. ومع ذلك لزم التنبيه إلى وجود شخصيات عسكرية وطنية شريفة ذات مهنية عالية لكنها للأسف خارج دائرة الفعل.
أزمة اجتماعية وسياسية حادة تغذيها بعض التدخلات المتكررة من أطراف دولية مؤثرة في الشؤون الداخلية الأمر الذي أدى إلى ردود فعل سلبية من جانب النظام ستؤدي في حال تكرارها والإصرار عليها إلى انهيار العلاقات بينها وبينه وبالتالي رفع يدها عنه.
أوضاع اقتصادية تتميز بعدم الاستقرار ومناخ الأزمة الذي بدأت أعراضه تظهر في العمود الفقري للاقتصاد الوطني(شركة اسنيم) التي ستؤدي تصفيتها أو خصخصتها إلى ردود فعل نقابية قوية تهدد السكينة العامة.
□ أما الخيار الأفضل في هذه المرحلة وفي هذه الظروف فهو خيار الثورة الناعمة والتغيير الهادئ المتدرج أو التصحيح من الداخل : وهو أن تكون الأغلبية قادرة على فرز حل من داخلها يضمن استكمال أسس دولة القانون والمؤسسات وهو ما يقتضي القيام بثورة هادئة على النظام التقليدي واستبداله بنظام أكثر عدلا وإنصافا وأكثر انسجاما مع مقتضيات الحكم في القرن الواحد والعشرين وبدون هذا التحول سيظل نظامنا السياسي يكرر نفس التجربة ويعيد إنتاج نفسه إلى ما نهاية.
وفي الحقيقة فإن كل الأمور البشرية نسبية وتقوم على قاعدة التدرج، ومنطق حرق المراحل للأسف هو إحدى قواعد التفكير الخاطئة التي تحكم عقلنا السياسي : فبين الانتقال من لا شيء إلى كل شيء توجد مرحلة وسطى يتعين المرور بها أولا لضمان الانتقال الآمن والذي يحمل صفة الديمومة.
إن العمل بهذا الخيار يقتضي القيام بجملة من الإجراءات سواء تعلق الأمر بالملفات المستعجلة التي تنتظر الحكومة المنبثقة عن الانتخابات الرئاسية المقبلة أو بأسلوب التعامل بين الحكومة الحالية والمعارضة في فترة ما قبل الانتخابات وهذه الإجراءات نستطيع حصرها في ثلاث نقاط هي:
حل الأزمة الاجتماعية بالإعلان عن إجراءات عاجلة شجاعة لحل الإرث الإنساني للعبودية وفي مقدمتها التطبيق الكامل لبنود خارطة الطريق المتعلقة بأشكال العبودية المعاصرة
حل الأزمة السياسية واتخاذ تدابير شجاعة للانفتاح على المعارضة وكسر حاجز انعدام الثقة والقيام بتنازلات من جانب واحد في هذا الصدد.
التوصل إلى تفاهمات تقضي بعدم مساءلة الرئيس وحكومته عن أخطاء التسيير منذ سنة 2005، والإعلان في المقابل عن ميثاق وطني للتشديد ضد الفساد وتحديد عقوبات رادعة ضد الفساد والمفسدين يقضي بحرمان الضالعين فيه من تسيير الشأن العام من موقع قيادي لفترة لا تقل عن 10 سنوات.
وترتبط بهذه النقاط الثلاث حزمة من الإجراءات القبْلية (apriori) في مقدمتها الاتفاق على صيغة أو ميثاق يسمح بتعديل أحكام الدستور بما يسمح بما يلي:
□ الاتفاق على استحداث منصب نائب الرئيس يقرن به عند الترشح ويجري التصويت عليه في الانتخابات ويحل محله في حالة الوفاة أو العجز أو الاستقالة الطوعية دون أن ينقص ذلك من حقوقه الدستورية.
□ إعادة تشكيل اللجنة الوطنية المستقلة للانتخابات بشكل يضمن وجود تمثيل متساو بين الأغلبية والمعارضة بأصنافها التقليدية والجديدة
□ إعادة تشكيل المجلس الدستوري بما يسمح بتمثيل مقبول للمعارضة التقليدية حتى ولو تضمن ذلك تعديلا لأحكام الدستور
□ إعادة تحديد المهام المتعلقة بالجيش ووضع الشروط الكفيلة بعدم تدخله في السياسة
□ إطلاق سراح النائب عن حزب الصواب بيرام ولد الداه ولد اعبيد بأمر قضائي
□ الإعلان عن سياسة اجتماعية تقضي بخفض الأسعار وإعادة توزيع الخدمات الصحية وتعميمها وخفض تكاليفها لتكون في متناول الجميع
□ وضع خطة مستعجلة لإصلاح التعليم بتخصيص ميزانية لا تقل عن % 30 من الميزانية العامة للدولة وزيادة أجور المدرسين إلى 30000 أوقية جديدة وجعل التعليم هو محور العمل السياسي والوطني الحقيقي لأنه هو بالفعل كذلك. وبما أن المقال ينحو منحى الدراسات المستقبلية فإنه يحق لنا التنبؤ بما سيحدث إذا لم يتم العمل بروح هذه النقاط الثلاث أو مادتها:
□ حرمان المعارضة نفسها من المشاركة في صنع التاريخ وحماية التجربة الديمقراطية وتطويرها
□ تورط الأغلبية في أخطاء قاتلة ترجح كفة الخيار الأسوأ.