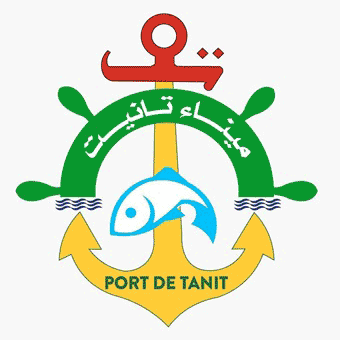يخلط بعض الموريتانيين بين العاطفة الدينية وبين الكهنوت الديني، تماما كما يخلطون بين الرق والفقر، فيرون كل فقير رقيقا، ويذهبون إلى أن أي دفاع عن المقدسات العامة هو من قبيل الكهنوت والقمع باسم الدين. الأمر ليس كذلك أبدا.
عندما يُفرض الدين على الناس معززا بالقوة يصبح كهنوتا، وعندما تؤمم الدولة المؤسسات الدينية تصبح جزء من القطاع العام، وتأخذ من فشله وأدوائه، وتفقد صبغتها الروحية والحيادية شيئا فشيئا، لكن بين الحالتين فرق كبير، في الأولى يخسر المتدينون لأنهم يكرهون على إيمانهم وفي الثانية يخسر الدين ذاته لأنه يصبح خارج الحياة.
في ظل الدولة السلطانية "الإسلامية" رفض الإمام مالك بن أنس،عالم المدينة الأجل، فرض كتابه الموطأ على الناس في الدرْس والفُتْيا، وكان بمكنته ذلك، وهي الحالة الغالبة على علماء السنة، باستثناء محاولة المعتزلة فرض رأيهم على العموم في ظل المأمون، وهي محاولة باءت بالفشل.
ومع ذلك ظلت السلطة تستميل العلماء وظل هؤلاء بحاجة لدعم الحاكم، لكن العلاقة بين السياسة والدين، ظلت وفية "لإجماع" تاريخي توافقي لم يتفكك إلا بعد الاستعمار وصعود الدولة الوطنية.
الجديد في المسألة هو أن حالة الدولة المأزومة سحبت وضعها على الفقهاء، حيث نزعت منهم سلطة التشريع، لأنها أقصتهم من الفعل العام، ثم زاحم القانون الشريعة، وأبعدها في بعض المجالات، ما أنتج وضعا قلقا عكسته الأدبيات التوفيقية، فتم الحديث عن الدولة والمجتمع والشريعة والقانون والأصالة والمعاصرة، للتعبير عن الشعور العميق بالأزمة والحاجة إلى التوفيق بين القيم والمصالح وبين المبادئ و الواقع وبين الخصوصية والكونية...
لكن الحالة الموريتانية لم تعرف توظيفا عنيفا للدين من قبل الدولة، كما لم تعرف تهديدا جديا للقيم الإسلامية العامة، والسبب الأول هو بساطة التدين المحلي وتكوينه المؤسسي الأهلي.
وفي ظل الدولة الوطنية كان الإمام بداه بن البوصيري (بل الله ضريحه) جزء من المشهد الرسمي العام، لكنه عندما أظهر نزوعا مبكرا للتجديد واجهه الفقهاء بالنكير والرفض، وهو خريج المؤسسة العلمية الأهلية ذاتها التي ينتمي إليها خصومه. المقصود أن الجدل هنا كان داخل المؤسسة الدينية وليس خارجها.
اليوم ليست هناك خشية من سلطة "رجال الدين" بل الخشية تكمن من توظيف الدين من قبل السلطة لقمع معارضيها أو لفرض توجه ديني بعينه. من هنا يصبح الحديث عن الحاجة للعلمانية بلا معنى وتكون "أسْلمة" الدولة غير مقنعة.
عندما حدثت واقعة الدفاع عن الجناب النبوي، تفاعل معها الجميع، وهي الحالة الطبيعية، لكن توظيفها من قبل السلطة، كان بداية انحسارها، وعلى الجانب الآخر بدا وكأن نقد "القمع الديني"، مجرد شعور بالمرارة تجاه فئة بعينها "تحتكر" الخطط الدينية تاريخيا، فتراجع التعاطف من "دعاة الحرية" مع المذكور و ذويه.
العلمنة القصوى، أو هكذا أسميها لم تحدث محليا ولم يدع إليها أحد، كما أن استخدام المقدّس في السياسية ليس مزعجا لأنه ما يزال ضعيفا نظرا للطابع المهيمن للفقهاء التقليديين وأصحاب البركة، وهؤلاء جزء من التدين العام وليسو تعبيرا عن "الإسلام السياسي" كما يسمى، إذا؛ لسنا بحاجة إلى العلمانية لحماية "الحرية الفردية"، و بالمقابل لا خشية على الدين، لأنه ما يزال مجالا مشتركا بين الجميع. الحديث عن العلمانية مبالغ فيه والخوف على الدين ليس مبررا.
قصارى ما يحدث محليا هو مواقف شعبية عاطفية لرفض المساس بالرموز الدينية المحلية أو العامة، وهو شعور صادق لكن الخوف يبقى في المقام الأول من استغلاله سياسيا من قبل الدولة، وقد تظهر بالمقابل نزعات حداثية شبابية هي مجرد تعبير عن الانبهار بالموضات الثقافية والسلوكية الغربية وليست شيئا آخر.
أقول ذلك لأن أهل الخيام لا يعرفون شيئا عن التراث الفقهي الإسلامي وتنوعه وتعقيده، ومن باب أخرى أن يدركوا عمق التجربة الغربية المفارقة زمانا ومكانا.
كل ما يتم الحديث عنه في مجتمعنا هو من قبيل المزاج العام وتقلباته كما يتقلب الطقس بين الصبح والمساء، وهو أيضا تعبير عن الخصاص المبين في تدبير الحقل الديني والنقص الفاضح في التفاعل مع المعرفة الإنسانية المفيدة. وعندما يسود الجهل يستباح كل شيئ وحين يتم تسييس كل الأمور تصبح خاوية على عروشها، سواء أكانت أمور العلم أو السياسة ذاتها وحتى الدين.
رمضان كريم