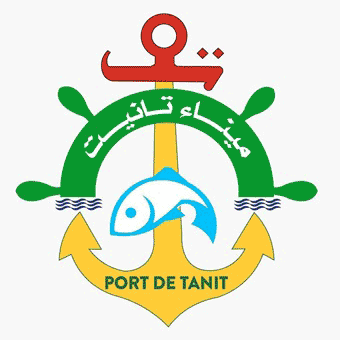كان أحمدو ولد مبارك فال رحمه الله المشهور بكنيته باتلينغ سيكي رجلا عظيما وبطلا منسيا من أبطال الأمة الموريتانية وقد حاول جيراننا السنغاليون الاستحواذ على ذكراه واحتكار الرسالة النبيلة التي أوصلها باسمنا وباسم الإنسان الإفريقي إلى العالم أجمع وليست حالته هي أول ولا آخر السرقات الثقافية السنغالية فهم كما عهدناهم على ما هم عليه من شطارة وخفة يحاولون سرقة كل شيء في هذه القارة لذا ناكفوا على الفرعونيات القديمة مصر البعيدة واختلسوا في أخيلتهم الشطاحة الحبشيات العتيقة وجعلوا بلقيس (الإثيوبية – اليمنية) بزخرف القول واحدة من ولفياتهم وصوروا بحبر أقلامهم الطائشة كل ما هو أسود أو أسمر أو داكن مجرد مرحلة من مراحل تطور التاريخ السنغالي الغريب.
هذا الرجل الذي ألهم القائد الفيتنامي هوشي مينه وكتب عنه معجبا ومتعجبا أنه أول أسود يقبض المال لضربه لمستكبر أبيض, وانبهر به الكاتب الفرنسي بول فايان كوتيرييه وألهب مخيلة أمريكان مشاهير من نوع ارنست همنغواي وهاري ميللر لم يكن في حقيقة أمره إلا حرطانيا منا يختلج بموسيقانا ويعتمل بمشاعر التوق الأبدي للمساواة والحرية.. لقد دفعته نقطة القلق الوجودي هذه إلى العلى ومكنته من الوصول إلى العالمية.. لذا فلا عجب أن يتسمي به ثوار كوبيون وأن تتحول حياته الأوبرالية إلى عنوان لفرق موسيقية تضج بالعنفوان والتحدي.
ولد المرحوم أحمدو في قرية "أبجوص" في 16من شهر أيلول سنة 1897 وهي قرية تندغية سمراء تقع في أسفل لسان البربرية على مرمى حجر من مدينة أندر أو سان لويس التي كانت في تلك الأيام تنقسم لثلاثة أجزاء هي "قت اندر" وهو الحي الموريتاني دون منازع ويشتمل على كل قرى لسان البربرية حتى "ابدن واندياغو" والجزيرة الفرنسية التي كانت عاصمة لكل الغرب الإفريقي وحي "صور" الذي ظل وحده عاصمة السنغال وقبيل الاستقلال وقعت مقايضات تخلت فيها موريتانيا عن الجزء الجنوبي من الحي الموريتاني مستثنية بناء واحدا ما زالت تؤجره حتى الآن منظمة استثمار نهرالسنغال ورسمت الحدود عند أطلال فيلا الغارديت حيث تقف الآن أشجار طويلة.
في تلك الأيام كان الناس في كل القرى المجاورة يسجلون مواليدهم في سان لويس كي ينعموا فيما بعد بحقوق المواطنة الفرنسية التي يعطيها القانون الاستعماري لسكان البلديات الأربع( سان لويس, ريفيسك, داكار, غوريه) ويعتاشون من أفياء المدينة ولذلك بناء على الأوراق الثبوتية بنى المتثاقفون السنغاليون دعواهم متناسين في خلط متعمد خصوصية المدينة وحرطانية المعني.
وهكذا ما إن وقف الفقيد على قدميه حتى عرف طريقه إلى المدرسة اليسوعية بسان لويس التي ألزمته على تغيير اسمه فأصبح لويس فال وذلك لا يعني إطلاقا تغيير الدين أو اعتناق النصرانية لكنها عادات ذلك الزمان حيث تسمى كل طفل باسمين واحد للمدرسة وآخر للعائلة وإلا لجاز لنا اعتبار بليز دياجن الراقد أمام المقبرة الاسلامية بسمبديون نصرانيا وهو أمر روج له الكثيرون عن جهل ورفضته كنيسة داكار وقد شرح لي الأستاذ حسن دياجن قصة جده بشكل لا يدع مجالا للشك وقد أعود إلى تفاصيلها في وقت لاحق وهما لا يختلفان كثيرا عن المدير الحالي لمنظمة الأمم المتحدة للزراعة والتغذية السيد جاك ضيوف الذي تعرفت عليه منذ سنوات في الحرم المكي بالحجاز وقد شرح لي أن التسمية المسيحية في جيله لا تعني بالضرورة اعتناق المسيحية... بكل اختصار إن القول بنصرانية أحمدو ولد مبارك فال فيه ما فيه من زور وتكفير.
على كل حال لم يكتب لبطلنا طول مقام في المدرسة إذ سرعان ما انتزعه والده بنصيحة من الشيخ سعد أبيه من اليسوعية وعهد بتدريسه لمحظرة مكتظة في "قت اندر" بعد أن مكنه الرهبان على عجل من فك الحرف اللاتيني قراءة وكتابة.
المحظرة كما تعرفون يحبها الأطفال كثيرا فمناهجها تسمح بالتسكع في الطرقات وأخلاقياتها تشجع على التمسح والتسول وهكذا جال البطل في الطرقات واكتشف الأزقة المظلمة باكرا وجرر ذيوله على الجسور ثم وجد لنفسه مهنة مسلية ومدرة بالدخل وهي القفز السريع من فوق جسر فيديرب والغوص في النهر والتقاط أي قطعة نقدية قد تسقطها في الماء يد أوروبي عابر يريد امتحان البرعم الشجاع والتمتع بمشاهدة هذه الموهبة الرائعة.
ذات صباح وهو في الخامسة عشرة ربيعا انساب يخت فاخر قادم من أمريكا وفتحت له قناطر الجسر الحديدي ودار بالجزيرة الصغيرة حتى الرصيف الغربي وأناخ قرب جسر الأمير محمد الحبيب في مهجع اليخوت والسفن الصغيرة ونزلت منه حسناء هولندية تدعى غريس وكان صاحبنا من المبحلقين الصغار والمتلذذين عن قرب برؤية هذه الراقصة المشهورة والممثلة العالمية الكبيرة وقد لفت نظرها ببلوغه المبكر وبالملاءة السوداء التي تلف جسده الغض الذي يشبه في بهاءه إلها أبنوسيا غابرا فكلفته دون غيره بحمل أمتعتها ففعل ممتنا وتقدم إلى فندق البريد.
أحبت تلك الفاجرة الحدث الجانح وراودته عن نفسه وكادت أن تفارق الحياة عندما رأته يقفز أربعين مترا ليلتقط سنتيما رماه فرنسي متعجرف يحاول في تقربه لها ومغازلته اياها إبعاد الفتى الأسمر الصغير الذي تتبعه الحسناء المشهورة كظله و تلهث خلفه كالكلبة الشبقة لذلك ما إن عاد صاحبنا إلى الجسر حتى فهم مغزى العنصري فرمى السنتيم في النهر وأمر الفرنسي باستعادته فرفض متكبرا فأرسله بضربة واحدة إلى سنتيمه...
اعتقل على الفور وأودع السجن ولولا ما كان لعاشقته من حسن وتأثير لما خرج من السجن في أيام قليلة.. وهكذا سافر معها على متن اليخت بعد أن اتفقت مع شرطة البلدة على كفالته وإبعاده ولم يمانع كثيرا أهله خوفا عليه من انتقام الفرنسيين وفي معيتها نزل مدللا بباريس عاصمة النور ومدينة الشياطين والملائكة.
لم يكتب لقصة الحب الباكرة أن تطول فهي تكبره بعشرين سنة وأوربا من أكثر الأماكن عنصرية وكثيرون فيها من رفضوا في تلك الأيام منح صفة الإنسان لغير الأبيض من الناس متحججين في ذلك بداروينية قبيحة يلبسونها في عجالة آثمة لبوس العلمية والعقلانية.
أحس صاحبنا بأنه مخجل لعاشقته وأدرك أنه في حقيقة الأمر واحد من العجماوات المسلية في قصرها المنيف ففارقها وتحرر من العبودية الجنسية وفضل العمل كنادل في المقاهي وسرعان ما نشبت الحرب العالمية الأولى فاستدعي للتجنيد بأمر من كاتب الدولة للتجنيد الإفريقي بليز دياجن الذي التحق بباريس قبل ذلك بسنة واحدة كنائب للسنغال في الجمعية الوطنية الفرنسية وكان أول زنجي يدخل قصر البوربون.
أظهرت معركة فردان شجاعة الفتي وقدرته الغير مسبوقة على القتال فلقد كان عندما يأخذه العنف تطربه المواجهة ويتقدم إلى الموت كمن يريد تصفية حسابه مع الأقدار وكانت الحرب بالنسبة له لعبة مسلية وفرصة نادرة للانتقام من العنصرية ووسيلة جديدة لإذلال الرجل الأبيض المتجبر دون الخوف من مسائلة ومحاكمة.. كان قتل الألمان بالنسبة له وهو لا يعاديهم بالضرورة طريقة التفافية لقتل أبناء عمومتهم الفرنسيين فالأوربي أيا كان غاشم وعنصري.
الحرب العظمى كانت مناسبة رائعة للبرهنة على أن الإفريقي هو أيضا كائن فتاك وقتال وهكذا لما انتهت الحرب تطرز صدره بصليب الشجاعة الفرنسية وعلق على عنقه نوط الجدارة الجمهوري وعاد إلى الحياة العادية يبحث عن وسيلة عنيفة تشبه الحرب ينفس فيها مكبوتاته ويطلق بها الغصات الحرّى المحبوسة في صدره فوجد في رياضة البوكس مبتغاه.
في العشرين استطاع احتلال مكانة متصاعدة القيمة على الحلبة ناقلا بلكماته المدوية غضب القارة السوداء وحنقها المرير وتألق كثيرا في أسلوبه الجديد وسافر إلى أمستردام ودبلن وأصبح يعد من أكبر المصارعين في العالم ولقد أرى هذا الحرطاني الجبار كل من سولت له نفسه مواجهته عجبا وأذاقه طعم الاندحار وعلقم الذل والهزيمة ولم تكن نجاحاته سهلة ولا بسيطة .
في يوم من أيلول سنة 1922 كان عليه بعد أن تجاوز كل العقبات والتصفيات أن يواجه بطل العالم في البوكس جورج كاربانتييه ونظم اللقاء التاريخي في ملعب بيفالو في مونتروج قرب باريس وحضره قرابة خمسين ألف إنسان أتوا ليشاهدوا الصراع بين الآدمي العملاق وقرد الشيمبانزيه القادم للتو من الغابة كما عنونت جل الجرائد العالمية الخبر في صفحاتها الأولى وبحضور الجميع انتصر الموريتاني العظيم وأردى بطلهم حطاما متكسرة لكن الحكم العنصري فاجأ الناس برفض إعلان النتيجة وحصل هرج كبير كاد يقتله فيه الناس منحازين للحقيقة ولفطرة العدل فتراجع الحكم وأعلن على مضض فوز صاحبنا كبطل العالم أجمع في بوكس الوزن الثقيل. (انقر الرابط لمشاهدة لقطات من المباراة العظيمة)
واصلت الجرائد العنصرية المهيمنة حملتها على الفتى وراحت الاتحادية الفرنسية تجمد النتيجة واحتدم نقاش غريب حول إنسانية الموريتاني وجدارته باللقب وارتفعت الأصوات تحت قبة قصر البوربون بين مؤيد ومعارض ثم حكم القضاء بأحقية أحمدو واعتذر له بليز دياجن باسم الرئيس اليكسندر ميليران نيابة عن الجمهورية بأكملها.
أصبح أحمدو غنيا ومشهورا ولم يكن لحداثة سنه وقلة تعليمه جيدا في إدارة موارده ولا في تسيير سمعته فطفق يتسكع في الشوارع مصطحبا معه شبلا صغيرا مفترسا لإخافة المارة ومضايقتهم بل كثيرا ما تركه يتحرش بأنيابه الصغيرة الحادة بكلاب الناس و وصلت به الجرأة في إحدى المرات إلى إطلاق العنان لقردين مزعجين يزئر بينهما شبله المخيف في مقهى مونبارناس وكل ذلك لإذلال جماعة دادائية فوضوية من أصدقاءه يأخذ عليها صمتها المطبق حين كانت الجرائد تكيل له الشتائم...
راح يشتم الكنيسة ويلعن الجمهورية الفرنسية ولم يبالي بنصائح السلطان المغربي المنفي مولاي عبد الحفيظ الذي كان أنجاله من محبيه ومناصريه...وكان صاحبنا يطلبه الدعاء له قبل كل مواجهة وتمادى في رشده وغيه وتزوج من ثلاث فرنسيات في يوم واحد ساخرا من القوانين الغريبة التي تمنع تعدد الزواج.
لقد ملء أحمدو ولد مبارك فال باريس ضجيجا وزعيقا وانتقم منها على طريقته فضاقت عليه وحجرت أمواله فسافر إلى الشاطئ الآخر واستقر في شقة راقية بالشارع رقم 41 في منهاتن نيويورك.. ولم تكن حاله في نيويورك أحسن حالا من باريس فقد كانت الولايات المتحدة ساعتها بلد التمييز العنصري الأكبر في العالم وهكذا كان يدخل المقاهي البيضاء عنوة ويحوّل أبواب الحانات العنصرية إلى حلبات مرتجلة لرياضته المفضلة.. خاب أمله ووئد حلمه الأمريكي سريعا فتسلق صنم العبودية الذي يسمونه تمثال الحرية وبال عليه ضحى على مرأى من الجميع.
نلاحظ انه رغم صدق الرجل واستعراضيته لم تثمر أعماله بالنجاح لافتقادها رغم جماليتها للحصافة والنكهة السياسية فظلت لهذه الأسباب أعمالا فردية ومرتجلة تستتبع من الأضرار أكثر مما تنتج من الفوائد.
اغتيل بالرصاص وهو بعد في الثامنة والعشرين ربيعا..مخلفا بركة من الدم على رصيف شارع هيلس كيتشن وسجلت الجريمة ضد مجهول.. ودفن بطلنا على عجل في قبر مغمور في ضواحي نفس المدينة وقد زرته وصليت عليه صلاة الغائب التي حرم منها وانوي في القريب العاجل تأدية الحج بالديار المقدسة نيابة عنه...ومنذ سنوات قليلة نقل السنغال رفاته الى سان لويس ولم ينزعج احد في موريتانيا !!
أنا كمواطن من موريتانيا وكمسلم أطالب بإستعادة رفات هذا الرجل الاستثنائي إلينا ودفنه ابجوص كي تنعم روحه بالطمأنينة ...
وأطالب النخب المثقفة بالتمعن في معاني تجربته الفريدة التي رغم ما فيها من غوغائية وصبيانية طائشة حملت في طياتها وثناياها أعظم مآسينا وكانت في حد ذاتها إرهاصا للنضال العالمي ضد العنصرية المقيتة ولنا أن نفاخر به فقد سبق مواطننا هذا أيقوناتهم المقدسة من نوع مارتن لوثر كينغ ونلسون مانديلا بعقود وألهم الناس والمستضعفين في إفريقيا وآسيا وأمريكا ومن الشرعي أن يلهم بعضنا ولو شيئا من الملاكمة والضجيج والعويل.