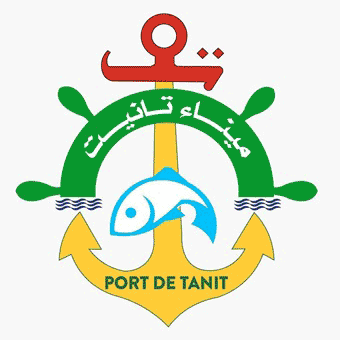ثمة فرق كبير من الناحية التاريخية بين الإسلام وبين الأديان الأخرى. فالإسلام هو الدين الوحيد الذي تضمنت نصوصه التشريعية مساحة كبيرة للإجابة على ما دعاه الفيلسوف السياسي الأميركي غرين تندر “الأسئلة الأبدية” في السياسة، مثل: هل من حاجة إلى السلطة؟ وكيف يمكن التوفيق بين المساواة بين الناس والحاجة إلى بناء هرمي للسلطة فيه آمر ومأمور؟ ومن يحق له أن يحكم الآخرين، وبأي حق يحكم؟
ولا يوجد دين على وجه الأرض خصصت نصوصه مساحة للإجابة عن هذه الأسئلة كالدين الإسلامي. ولو أردنا أن نقارن بين الإسلام والمسيحية، وهي المقارنة الشائعة -بحكم التلاقي والتلاقح اليوم بين الثقافة الإسلامية والثقافة الغربية ذات الجذور المسيحية- فسوف نجد أن هناك اختلافًا كبيرًا في ظروف النشأة والمولد، ترتب عليه اختلاف عريض في الموقف من المسألة السياسية.
فقد ولدت المسيحية من رحم دولة قائمة، هي الإمبراطورية الرومانية، التي كانت تحكم آنذاك حوض المتوسط كله بما في ذلك فلسطين. أما الإسلام فقد ولد في فراغ سياسي في الجزيرة العربية. وبين قوم كانوا يكرهون الدولة والسلطة والقانون والنظام. وكان شاعرهم يفخر بقوله:
من عهد عاد كان معروفا لنا أسْرُ الملوك وقتلها وقتالها
فالمسيح عليه السلام جاء إلى مجتمع فيه دولة قائمة، فلم يبن دولة، وإلى مجتمع محكوم بتشريع -هو التشريع الروماني- فلم يسُنَّ ترشيعا. ولذلك نجد في المسيحية عقائد وشعائر وأخلاقا، لكننا لا نجد تشريعات. وقد ظلت المجتمعات المسيحية محكومة بالقوانين الرومانية منذ ما قبل المسيح إلى مطالع العصور الحديثة.
أما المجتمعات الإسلامية فليس هذا شأنها: فقد حُكمت بقانون إسلامي طيلة تاريخا إلى مطالع العصور الحديثة. وبغض النظر عن مستوى الالتزام بذلك القانون، لكن المهم أنه قانون ذو صبغة مميزة، هي الصبغة لإسلامية.
وبنى نبيّ الإسلام دولة، وكان هذا حال أنبياء الديانات السامية عمومًا، ففي كلها كانت السياسة جزءا من تعاليم الدين، وفيها كلها امتزجت النبوة بالقيادة السياسية والعسكرية. وكلنا نعرف قصة أنبياء بني إسرائيل الذين كانوا أنبياء وساسة، ومنهم دواد وسليمان ويوسف عليهم السلام. فالمسيحية تمثل حالة استثنائية من هذه الحالة العامة، وهي لذلك حالة لا تقبل التعميم، فالمنظور المسيحي في السياسة أقرب للمنظور البوذي منه إلى الديانات السامية.
في كتابي الجديد الذي سيصدر قريبًا بعنوان: “الأزمة الدستورية في الحضارة الإسلامية” ناقشتُ القيم السياسية الإسلامية التي تضمنتها نصوص القرآن والسنة. وقد جمعتها في حوالي ست وعشرين قيمة سياسية كبرى، وهي تنقسم إلى قسمين:
– قيم تتعلق ببناء السلطة.
– وقيم تتعلق بأداء السلطة.
فمن قيم بناء السلطة مثلًا قيمة الشورى، بمعنى حق الناس في اختيار من يقودهم، وحقهم في محاسبته وعزله، لأن الجماعة هي مصدر الشرعية السياسية. ومنها: قيمة التمثيل السياسي، لأن الناس لا يمكن أن يمارسوا السلطة بشكل مباشر، وفي التاريخ دليل على عدم إمكانية ذلك، فقد انهارت الديمقراطيات المباشرة كديمقراطية أثينا، لأنها لم تقم على أساس نظام هرمي تمثيلي. ومن ضمن قيم البناء السياسي أيضًا: واجب لزوم الجماعة، ووحدة المسلمين، وطاعة السلطة الشرعية، وعقد البيعة …….الخ.
أما الصنف الثاني من القيم (قيم الأداء السياسي) فمنها: التزام السواد الأعظم، وهو ما نعبر عنه باللصطلاح المعاصر بخيار الأغلبية، باعتباره معيارًا من معايير حسم الخلاف في الشأن العام. ومنها: الأخذ على يد الظالم، واعتبار المال العام “مال الله” –كما تصفه الأحاديث النبوية- من أجل إضفاء نوع من القداسة عليه، ومنع أيدي المعتدين من الوصول إليه. ومنها توصيف المنصب العام نفسه باعتباره أمانة لدى متولّيه، وليس مِلْكية شخصية يتصرف بها كما يريد، أو يورّثه لأبنائه وأحفاده. ومن قيم الأداء السياسي في الإسلام أيضا: “القوة بمعنى الكفاءة السياسية، وهي صفة ينبغي أن يتصف بها المتقلد لأي منصب عام. ومنها: رفق الراعي بالرعية، ومنع احتجابه عنهم، ومنع الإكراه في الدين…الخ
قيم سياسية كثيرة فصّلتها شعرات الآيات القرآنية ومئات الأحاديث النبوية الصحيحة السند. ولكن المفارقة تكمن في أن الثراء الكبير في القيم السياسية في النص الإسلامي يقابله فقر كبير في المؤسسات والإجراءات في تاريخ المسلمين. وهذا الفقر في المؤسسات والإجراءات الذي منع تجسيد القيم السيسية الإسلامية في واقع معيش يمكن أن نجد له جذورًا تاريخية في البيئة العربية القبلية التي كانت تتمنّع على فكرة الدولة، وكان شعراؤها يفخرون بعدم خضوعهم لمنطق الدولة ومنطق السلطة. فبينما كانت شعوب الامبراطوريات المحيطة بالجزيرة العربية تسجد لملوكها كان الشاعر العربي يقول:
إذا بلغ الفطام لنا صبي يخر له الجبابر ساجدينا
وهو منزع فوضوي في الثقافة العربية لا تزال ملامحه موجودة إلى اليوم. وقد كان ذلك الفقر الإجرائي والمؤسسي سببًا أساسيًا من أسباب الفتنة الكبرى، وما تلاها من ثورات ومواجهات دموية في القرن الأول الهجري، كثورة الحسين، وثورة ابن الزبير، وثورة التوابين، وثورة الأشعث.
ثم إن معاناة القيم السياسية الإسلامية من هذا الفراغ التاريخي في المؤسسات والإجراءات أضيفت إليها معاناة أخرى، هي ضغط النماذج الامبراطورية المحيطة بالجزيرة، والتي كانت جاهزة لتقديم البديل السياسي، عقب انفجار الخلافة الراشدة من الداخل بسبب الفوضى السياسية العربية.
وعندما بدأ العصر الحديث جاء بتحديات جديدة أهمها: مفهوم العلمانية، وهو مفهوم غامض جدًا، وخصوصًا في ترجمته إلى اللغة العربية، ولكنني أعتقد أن العلمانية تطور طبيعي لمجتمع لم يكن دينه يشرّع أصلًا للدولة، ولا كان يتضمّن قانونًا، كما شأن الديانة المسيحية والبوذية. أما العلمانية في العالم الإسلامي، فلا يمكن أن تكون إلا خيارًا قهريًا، إذا صح تسمية القهر خيارًا أصلًا. فالعلمانية في الغرب تطور ثقافي طبيعي، والعلمانية في العالم الإسلامي قهر وجبر بواسطة قوة متسلطة داخلية أو خارجية.
ولعل تركيا مثال ساطع على القهر الذي فُرضت به على الدولة والمجتمع أشدّ أنواع العلمانية خشونة. لكن أق الدارسين للعلمانية التركية –مثل صمويل هنتغتون وأحمد كورو- أدركوا أنه كلما توسعت مساحة الحرية في تركيا توسعت معها مساحة الإسلام، وحضوره في الشأن العام. صحيح أن تركيا لا تزال دولة علمانية، لكنها انتقلت من “العلمانية الخشنة” المعادية للدين إلى “العلمانية الناعمة” المرحبة بالدين، وهو تقترب كل يوم من جذورها، وتتصالح مع هويتها، في طريقها إلى التحول إلى النظام السياسي الإسلامي.
لذلك أعتقد -على عكس ما ذهب إليه وائل حلاق- أن الدولة العلمانية مستحيلة في العالم الإسلامي، ففهم القيم السياسية الإسلامية، وقراءة التاريخ السياسي الإسلامي، ورصد واقع المسلمين اليوم، كله يدفع إلى الاعتقاد أن الدولة العلمانية مستحيلة التحقق في العالم الإسلامي اختيارا، وأن فرضها بالقهر والجبر الذي كان سائدا أصبح مستحيل الاستمرار أيضا، بعد أن خلعت الشعوب ثوب الذلة، وخرجت في ثورات الحرية والكرامة التي نعيشها اليوم.
وبالمقابل أيضا أعتقد أن الدولة السلفية مستحيلة. أما استحالة الدولة العلمانية فسببها أنها قائمة على أساس إزاحة قسم كبير من التشريع الإسلامي، والقيم السياسية الإسلامية التي تعلق بها وجدان المسلمين، وأما استحالة الدولة السلفية فلأنها تريد استنساخ التاريخ بدلًا من استلهام الوحي، وما أكبر الفرق بين مَن يستلهم الوحي ومن يستنسخ التاريخ. واستنساخ التاريخ أمر مستحيل عمليا، إضافة إلى أن جل تاريخ المسلمين كان تاريخا سلطانيا قهريا، ولم يكن متأسسا على القيم السياسية الإسلامية المنصوصة في القرآن والسنة.
وفي ضوء استحالة الدولتين العلمانية والسلفية، لا بد من اجتراح خيار ثالث، ينبذ المسار العلماني المفروض بالقهر، ويرفض الخيار السلفي الذي يستنسخ تجارب تاريخية لن تعود ويحاول تطبيق منطق الماضي على الحاضر.
هذا الخيار هو الدولة الديمقراطية ذات المرجعية الأخلاقية والتشريعة الإسلامية. فذلك هو الخيار الوحيد الذي ينسجم مع قيم الإسلام السياسية المنصوصة، ومع تطور التجربة الإنسانية اليوم في مجال الإجراءات والمؤسسات.
وذاك حديث آخر، لا يتسع المقام للخوض فيه الآن ضمن هذه العجالة..