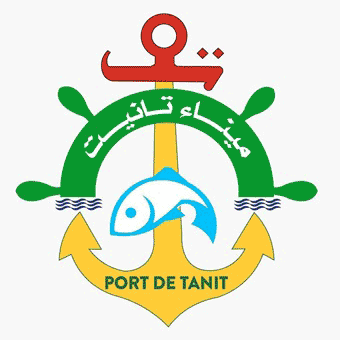تتحمل فرنسا جزءا كبيرا جدا من المسؤولية عن تكريس الرق في موريتانيا، وذلك بسبب تساهلها، محاباتها و طيبتها إزاء اللوبي الإقطاعي الموريتاني؛ شريكها والمتواطئ معها، بحيث لم تخضعه لمرسوم 12 ـ 12 ـ 1905 الذي كانت مستعمرة موريتانيا الوحيدة المعفية منه ضمنيا. وجد المستعمرون من تلامذة مدرسة المتأسلم كوبولاني، والمتمثلة في الاحترام الدقيق للإسلام السني؛ تشجيعا من علماء الأمراء المرغمين على تأويل القرآن والسنة وفق المذهب المالكي بمعنى شرعنة الرق. وبهذا الخصوص كتب الرائد فرانسوا بيسلاي قائد أركان الجيش الموريتاني سنة 1961: "فيما يعني الخدم أعتقد أنه، دون السعي للعب بالكلمات، لا بد من التمييز هنا بين وضعية الخدم غير الأحرار، أي الموالي، وبين وضعية العبيد. فمن الناحية التطبيقية لم يكن هناك في الواقع عبيد في موريتانيا؛ علما بأن هذه العبارة تعيد للأذهان بشاعة تجارة السود والعبيد المكبلين بالأغلال الذين يتم شراؤهم ثم يباعون في جزر الآنتي وأمريكا الشمالية. لم يكن هناك، ولم يوجد بعد سوى خدم وخادمات تعود تبعيتهم، فعلان لسيد وبالتالي هم مندمجون ضمن أسرته في السراء والضراء.لقد كانوا، دون شك، في أدنى السلم الاجماعي، مكلفين بجميع الحاجيات الخدمية لكن عددا منهم كانوا يجدون في ذلك مكانتهم؛ متقبلين عن طيب خاطر تلك الوضعية التي تضمن لهم الأمان، وكانوا يدينون بالولاء لسيدهم كما كان يفعل عندنا، قديما، خدم النبلاء المتشبثون ـ مدى الحياة ـ ببعض العائلات. وفي مجتمع ثقافة العصور الوسطى الذي كان يمثله المجتمع الموريتاني آنذاك، لم يكن هناك أي شيء صادم تماما. لكن الحاجز الاجتماعي لم يعد موجودا خارج نظر الشهود، وقد كان أحد قاطفي الصمغ يسير وحيدا في الطريق مع خادمه فيتقاسم معه زاده ببساطة وودية يمكن أن تشكل درسا للكثير من الديمقراطيين. صحيح أن تجاوزات اسيئت معاملة خدم من قبل أسيادهم. إلا أن عتقهم حينذاك في أغلب الأحيان لم يأت بأي حل؛ بل رمى بهم بكل بساطة، في وضعية من انعدام الأمان التام؛ دون رب عمل وبالتالي دون عمل: من كان يجرؤ، حينها، على استخدام خادم لآخر دون موافقته؟ كان ذلك يقود إلى استدعاء السيد السيء، بحضور الخادم، ليجبر على التعهد بمعاملةهذا الأخير بطريقة إنسانية، وإلا يتم انتزاعه منه بهدف تحريره. وعادة يتم تسوية كل الأمور بالتفاهم. وفي المقابل كانت الإدارة الفرنسية تعارض بشكل فعال بيع أي خادم؛ أي تعارض أي تغيير لرب العمل دون موافقة المعني وبالخصوص ضد أي فصل بين الأم وأطفالها أو حتى بين الخادمة وزوجها. وقد وقعت محاولة عتق جماعي لخدم الرقيبات لقواسم سنة 1944 من طرف السلطات الفرنسية. وتم التراجع سريعا عن ذلك. فقد تدفق السود الهاربون على قافلة جمّالة الصويره التي كان تنتج بين بير أم اكرين و تيندوف؛ وكان يجب إطعامهم؛ كما كان ارقيبات لقواسم جاهزين للدخول في عصيان إن لم يعاد لهم من يؤدي غيابهم إلى حرمان القطعان من الرعاة. مع مر السنين، وتحت الضغط الدائم من السلطات الفرنسية التي كانت ترفض الاعتراف بأي حق في الملكية في هذا المجال؛ انتقل العديد من الخدم ، تدريجيا، من حالة خادم إلى حالة عتيق؛ أي أن البعض كانوا يتلقون أجورا.. ولأنهم أحرار في الابتعاد عن أسيادهم السابقين، فقد كانوا يعملون لحسابهم الخاص، لدرجة أنه في سنة 1958؛ أي بعيد إرساء الاستقلال الداخلي، كان نائب رئيس مجلس الحكومة، المختار ولد دلداه؛ خلال زياراته العديدة لسكان البوادي، يواجه الوجهاء الذين يصرون على مطلب أساسي: "الآن وقد أصبحنا جمهورية إسلامية، أعد لنا ما يقر لنا القرآن بملكيته!. إلا أنه في حدود سنة 1965، ذكر لي مسؤول في شركة ميفيرما بالزويرات أنه كان يستقبل، أحيانا، زيارة بعض البيظان يطالبون بأن تدفع لهم رواتب "خدمهم" العاملين في المنجم! وبالعودة إلى سنوات 40 ـ 50، كان هناك للأسف متاجرة (غير مشروعة طبعا)، بـ "العبيد"، وأستخدم هذه الكلمة هنا لأن الأمر يتعلق فعلا بسود اختطفوا، بيعو وأعيد بيعهم ضد إرادتهم. كان العبد، آنذاك، يباع في جنوب المغرب مقابل 20 جملا! وقد كانت لي، شخصيا، الفرصة مرتين لمنع مهربين يمارسون هذا الوع من النشاط". انتهى الاستشهاد. يتبين مما سبق أن السلطات الفرنسية خلال فترة إرساء التهدئة كانت متساهلة جدا وساهمت في تحويل الرق إلى خدمة، والعبيد إلى خدم أو موالي. وقد عززت تلك السلطات سلطة الأسياد أو الملاك بمنحهم جميع الأراضي الزراعية من أجل استدامة هيمنتهم على غالبية أولئك الخدم الذين كانت وسيلتهم الوحيدة للبقاء هي العمل في استصلاح وزراعة الأرض. لم يكن لأي واحد من الخدم حق الملكية على الأرض المستغلة بفضل مجهوده ومجهود ذريته. ولم يأت الإصلاح العقاري سنة 1983 بأي تغيير على الوضع. فقد ظل الأسياد السابقون هم ملاك الأراضي وظل العبيد السابقون هم من يزرعون تلك الأراضي. وقد اغتنم الفرنسيون فترة إرساء التهدئة من 1900 إلى 28 نوفمبر 1960، فقاموا بالتحضير جيدا لفترة ما بعد الإستعمار التي بدأت منذ الإستقلال إلى الآن. شهدت هذه المرحلة فترتين متباينتين، فترة البناة المؤسسين، الممتدة بين 28 نوفمبر 1960 و10 يوليو 1978 والمتسمة بإرادة حقيقية لتقليص الفوارق وترقية المساواة التامة في المواطنة. وبهذا الخصوص صرح أب الأمة في يناير 1999؛ خلال مقابلة مع مجلة Jeune Afrique Economie قائلا: "إنه واقع سيوسيولوجي في موريتانيا. للأسف إرث متجذر جدا في عادات البلد، ونحن لم نستطع مواجهته مباشرة لأننا كنا بصدد إنشاء دولة على عجل، وانطلاقا من لا شيء. كان لا بد من حل المشكلة كلما كانت هناك حلول متاحة. لقد ألغى دستورنا لسنة 1961 الرق. وعلى مستوى التطبيق الإداري والقضائي تم إصدار التعليمات لقوات الأمن ووكلاء القضاء بعدم اعتبار الرق مؤسسيا وبمحاربته". أما الفترة الثانية، أي فترة الأنظمة الاستثنائية المدمرة، فهي التي بدأت يوم 10 يوليو 1978 وما تزال مستمرةإلى الآن. اتسمت هذه الفترة بتراجع في الحريات والقيم الأخلاقية، وكذا بتصاعد قوي للفوارق بين المجموعات وبين الجهات والقبائل بلغ ذروته مع عمليات الترحيل والإبادة. لقد أعد الفرنسيون جيدا، قبل رحيلهم،عملية تسليم تركتهم لورثتهم والمتواطئين معهم من زعماء القبائل وأبناء العائلات الكبيرة من العرب ـ البربر والزنوج الموريتانيين. وهكذا أرسوا في زوايا البلد الأربع مدارس أبناء الزعماء، التي تم بناء أولاها في بوتيليميت سنة 1914، وفي أطار سنة 1936، وفي كيفه سنة 1939 لإعادة إنتاج المجتمع الاستعماري بأشكال أكثر تحضرا وقبولا لدى السكان الأصليين. وكما يظهر من تسميتها كانت تلك المدارس تمنح الأفضلية، بجلاء، للنبلاء ومحرمة على الخدم والطبقات الدنيا الأخرى التي لم يكن المستعمرون يثقون بها ولا يعيرونها أية أهمية. لهذا السبب يجب أن يطلب من فرنسا أن تساهم مع الحكومة الموريتانية في تمويل صندوق للتضامن من أجل الكرامة، لفائدة ضحايا الرق أو الأشخاص ذوي الوضعية المشابهة، لجبر ما أمكن جبره من الأضرار التي تعرض لها المنحدرون من أولئك العبيد. فبالنسبة لفرنسا، تنحصر مسؤوليها بين 12 ديسمبر 1905؛ تاريخ بداية قمع الاتجار بالعبيد في مستعمراتها، و28 نوفمبر 1960. عليها أن تساهم بتعويض معتبر. إن مسؤولية الحكومة الموريتانية تبدأ من أول يوم على الإستقلال حتى نهاية هذه الظاهرة. الدولة الموريتانية يجب عليها، إذن، إنشاء صندوق للتضامن تقوم بتمويله في حدود 3% من ميزانيتها السنوية، اعتبارا من 1961. وسيتيح هذا الصندوق دمجا أفضل لمجموعة العبيد السابقين أو الأشخاص ذوي الوضعية المشابهة عبر منحهم تربية مواطنية حقيقية، مدارس، مراكز للتكوين، رؤوس أموال تؤمن لهم الإستقلالية، وكذا التكفلالتام بضمانهم الاجتماعي. لقد عزز الحكم الاستثنائ، دون شك، النظام الإقطاعي القائم على الفوارق الاجتماعية والاستبداد، أي مصدر انعدام الاستقرار؛ والذي خلفه المستعمر عبر إضفاء صبغة عصرية وليبرالية عليه؛ كما وصفه جيدا جينيفييف ديزيري في كتابها "تاريخ موريتانيا" : "قد يصور الخطاب الرسمي أن المجتمع القديم، ببسماته الثقيلة تم مسحه بعبارات اسقلال، ديمقراطية، أحزاب، تجمع، حرية... لكن تلك المصطلحات ذات الرنة العصرية لم تكن سوى تحويرات للأشكال القديمة للسلطة والسلطة الرقابية؛ والتي كانت من قبل تدعم التنافس والمواجهات بين العشائر أو القبائل.اليوم، حين يظهر فرد يرتدي دراعة أو بذلة بربطة عنق، يتم تعريفه تلقائيا من قبل بني وطنه على أنه ينحدر من شجرة نسب رفيعة، زوايا أو محاربين؛ من عائلة كبيرة، أو على أنه إبن استثنائي موهوب ومحظوظ لأحد الحراطين المغمورين". يتواصل